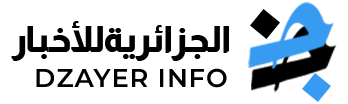هنري كيسنجر … تحول القوى

هنري كيسنجر || تحول القوى
ياسر عامر عبد الحسين
أنتهيت مع صديقي المترجم الجميل أحمد زاهد، من ترجمة مجموعة مقالات غير مترجمة لثعلب السياسة الأمريكية هنري كيسنجر، وسيُنشر الكتاب قريبًا بالتعاون مع دار آكاد العراقية تحت عنوان “سقوط الدبلوماسية في ظل الصراع النووي”
وهذه إحدى المقالات المُدرجة في الكتاب:
ترجمة: ياسر عامر عبد الحسين
تحول القوى || هنري كيسنجر
مجلة سُرڤايڤل، المجلد 52، العدد 6 (2010)، السياسة والاستراتيجية العالمية
مرّت أربعة وثلاثون عامًا منذ أن تشرفت بإلقاء أول محاضرة تذكارية لأليستير باكن في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. كان أليستير صديقًا عزيزًا لي، وناقدًا بناءً، ومصدرًا للإلهام لا ينضب. في عام 1976، اخترت اقتباسًا لأليستير كموضوع للمحاضرة: “التغيرات الهيكلية”. وكتب أليستير: “هناك تغيرات هيكلية تحدث في القوة والنفوذ للدول الكبرى؛ لقد حدث تغير كمّي هائل في الاعتماد المتبادل بين المجتمعات الغربية وفي المطالب التي نضعها على الموارد الطبيعية؛ وهناك تغيرات نوعية في انشغالات مجتمعاتنا”. لا تزال كلمات أليستير حكيمة وصحيحة حتى اليوم. فالعالم يتغير بوتيرة متسارعة، وتتغير معه موازين القوى والاعتماد المتبادل بين الدول.
ثم طرح أليستر السؤال التالي: “هل يمكن للدول الصناعية المتقدمة الحفاظ على جودة حياتها الوطنية وألا ترضي أجيالها الجديدة فحسب، بل أن تكون مثالًا أو قوة جاذبة للمجتمعات الأخرى؟” في عام 1976، أجبت على هذا السؤال ب”نعم”.
اليوم، سيكون موقفي أكثر ترددًا. فالتغييرات التي رأى أليستر أنها جوهرية في حينها، لم تكن سوى المراحل الأولى البسيطة نسبيًا نحو اقتصاد عالمي مترابط وعالم مليء بالأسلحة النووية. حينها، كانت الخطوط الجيوسياسية أو الاستراتيجية تمر عبر مركز القارة الأوروبية. أما اليوم، فمن المستحيل رسم خط فاصل واحد يجمع كل التصدعات التي تقسم عالمنا المعاصر.
استند خطابي، الذي بنيته على خبرتي كوزير خارجية للولايات المتحدة، إلى كيفية إدارة التنافس الأمريكي-السوفيتي بذكاء. كان هدفنا هو الحفاظ على الاستقرار وحماية الدول التي تعتمد علينا، مع ضمان السلام العالمي. في وقت إلقاء محاضرة باكن، كان النفوذ السوفيتي يتوسع استراتيجيًا نحو الجنوب الأفريقي. ناهيك عن التوتر المتزايد بين القوتين العظيمتين. ومع ذلك، شكل الإطار الثنائي القطبية، رغم سلبياته، عاملًا هامًا في منع حدوث كارثة نووية. لقد وفّر هذا الإطار، مع مرور الوقت، مساحة لتغييرات سلمية هائلة في النظام الدولي.
دعونا نقارن ذلك مع عالمنا المعاصر، حيثُ نرى فيه تغييرات جوهرية. فقد تحول مركز الثقل في الشؤون العالمية من المحيط الأطلسي إلى المحيطين الهادئ والهندي. كما حقق الاتحاد الأوروبي تقدماً ملحوظاً. بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهم هذا الاتحاد في تسريع التغيير في ممارسة القوة الوطنية المشروعة، وهو تغيير بدأ أصلاً مع تجربة الحربين العالميتين.
مع تراجع دور الدولة القومية ذات السيادة في ظل الاتحاد الأوروبي، برزت تحديات جديدة في صياغة السياسات والأهداف العسكرية. ففي ظل غياب الإطار الوطني الموحد، بات من الصعب تحديد المصالح الوطنية بدقة واستخدام القوة لتحقيق أهداف استراتيجية محددة. نتيجة لذلك، اتجهت الأهداف العسكرية للدول الأوروبية نحو حفظ السلام أو توسعت لتشمل مشاريع عالمية مثل تعزيز حقوق الإنسان وحماية البيئة ومكافحة الإرهاب. كما باتت تُنظر إلى المهمات العسكرية والتدخلات الخارجية كأشكال من العمل الجماعي وليس كمساعي قومية بحتة. أدى ذلك إلى جدل واسع حول الحروب التي خاضتها دول الأطلسي خلال العقدين الماضيين، ممّا أثار انقسامات داخلية وكشف عن اختلافات جوهرية في المشهد الاستراتيجي اليوم.
في الوقت الذي دعا فيه وزير خارجية أوروبي لسيادة أمريكا العظمى، برز تحدٍ جديد للنظام الدولي يُهدد مفهوم معاهدة وستفاليا القائم على الدول ذات السيادة. تمثل هذا التحدي في ظهور الإسلام الراديكالي، الذي أثبت صعوبة بالغة بالنسبة لنظام الدولة الويستفالي. فبطبيعته، يتجاوز الإسلام الراديكالي حدود القوميات ويرفض مفهوم السيادة الراسخ، سعيًا وراء نظام عالمي يشمل العالم الإسلامي بأسره. مما يُشكل تحديًا كبيرًا للنظام الدولي القائم على مبدأ الدولة القومية.
أما في آسيا فتتجه الدول الكبرى نحو اتباع استراتيجيات تختلف عن تلك المُتبنّاة في أوروبا، حيث تُولي أهمية قصوى لتشكيل هوية وطنية قوية وتُعزّز مفهوم “المصلحة الوطنية”. على سبيل المثال، أعلنت الصين عن “مصالح أساسية” غير قابلة للتفاوض، مُبدية استعدادها للدفاع عنها بالقوة إذا لزم الأمر. بينما لم تُصرح الهند بنفس الصراحة، إلا أنّ تحركاتها في مناطق استراتيجية تُشير إلى اتباعها نهجًا شبيهًا بأوروبا في أوائل القرن العشرين، بعكس توجهات الاتحاد الأوروبي في القرن الحادي والعشرين. كما تُظهر فيتنام استعدادًا قويًا للدفاع عن تعريفها الخاص للمصلحة الوطنية.
في ظل هذه الظروف، يصعب تطبيق المفهوم الكلاسيكي للأمن الجماعي. فافتراض وجود مصلحة مشتركة بين جميع الدول في حفظ السلام، وقدرة النظام الدولي المُنظم، من خلال مؤسساته، على حشد المجتمع الدولي نيابة عنه، بات يُعدّ افتراضًا يُكذّبه الواقع. فالهيمنة الواسعة للدول الكبرى على النظام الدولي الحالي، تُعيق وجود قناعات متطابقة أو حتى متماثلة كافية لتنظيم نظام أمن جماعي عالمي فعال على صعيد العديد من القضايا الرئيسة.
على سبيل المثال، تشكل مسألة انتشار الأسلحة النووية نموذجًا واضحًا. حيثُ تتعامل الولايات المتحدة وبعض حلفائها مع القضية على أنها مشكلة فنية. فيقترحون وسائل لمنع انتشارها ويعرضون العقوبات الدولية كحل. أما جيران كوريا وإيران فلديهم منظور مختلف، أكثر سياسية أو جيواستراتيجية. يكاد يكون من المؤكد أنهم يشاركوننا وجهة النظر حول أهمية منع انتشار الأسلحة النووية في محيطهم. ومن غير الممكن أن ترغب الصين في وجود كوريا أو فيتنام نوويتين على حدودها، ولا ليابان نووية، وكذلك لا ترغب روسيا في دول مجاورة مسلحة نوويًا – وهي عواقب محتملة لفشل سياسة منع الانتشار النووي. لكن الصين لديها أيضًا قلق عميق بشأن التطور السياسي لكوريا الشمالية، وروسيا لديها قلق بشأن العواقب الداخلية للمواجهة مع الإسلام. لقد عبر العديد من الغزاة الحدود الصينية على طول طريق يالو. حيثُ تقع المراكز الصناعية في منشوريا، بحيث لا تشعر الصين بالقلق من أن يؤدي الضغط على منع انتشار الأسلحة النووية إلى خلق أزمة أمنية على طول حدودها مع كوريا، وبالمثل، تُظهر روسيا قلقًا محدودًا من امتداد المواجهة مع إيران إلى المناطق الإسلامية داخل روسيا. لذلك، تقتصر رغبة كلتا الدولتين في دعم منع الانتشار على إجراءات لا تُهدد مصالحهما الاقتصادية. يمكننا تطبيق ذات التحليل على مسألة انتشار الأسلحة النووية الإيرانية. فكل من روسيا والصين تُفضلان اتخاذ إجراءات لا تُؤثر على مصالحهما الاقتصادية مع إيران، حتى لو كان ذلك يعني التغاضي عن بعض المخاطر الأمنية.
وبهذه الطريقة، يبدأ الأمن الجماعي بتقويض نفسه. فعلى سبيل المثال، فشلت عشر سنوات من المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بشأن برنامجي كوريا الشمالية وإيران النوويين في تحقيق نتائج تُذكر، ناهيك عن إنهاء هذين البرنامجين بشكل نهائي. أدى ذلك إلى تحول المفاوضات إلى أداة لكسب الوقت من قبل الدول المتهمة بانتهاك معاهدات منع الانتشار النووي. وبدلاً من التركيز على تبعات هذه الانتهاكات على الأمن الدولي، أصبحت إمكانية تحقيق نتائج ملموسة من خلال المفاوضات والعقوبات هي المعيار الأساسي لتحديد مسارها.
ومع ازدياد انتشار الأسلحة النووية، نواجه خيارين حاسمين: إما العمل الآن لمنع هذا الانتشار، أو مواجهة عالم جديد من عدم الاستقرار والخطر المتزايد للحرب النووية. في ظل هذا الواقع الجديد، قد تصبح أنظمة الأسلحة الاستراتيجية للقوى العظمى، والتي كانت تخضع لقيود معاهدات الحد من التسلح، هي الأداة الرئيسة لمنع الحروب بين الدول النووية. لكن هل يمكن للقوى النووية الحالية السماح بحدوث حرب نووية، حتى لو لم تكن متورطة بشكل كافٍ؟ نأمل ألا نصل إلى هذه النقطة، وأن نتمكن من تجنب سيناريو كهذا من خلال العمل الجماعي والدبلوماسي الحازم. من الضروري اتخاذ خطوات حاسمة الآن لمنع انتشار الأسلحة النووية وضمان أمننا المشترك. إن الوقت ينفد، ولا يمكننا تجاهل هذا التحدي الوجودي.
لابد أن نعرف إن أنظمة الأسلحة الحالية الأكثر تدميرا تشكل عقبة أخرى أمام نظام أمن جماعي عالمي، فهي إلى حد ما غير متناسبة مع المهام الموكلة إليها. لقد نجحت القوتان النوويتان العظيمتان، روسيا والولايات المتحدة، في تطوير أنظمة استراتيجية باهظة الثمن لا صلة لها عمليًا بالتحديات العسكرية التي يواجهها النظام العالمي اليوم. ولم يُفكر أي منهما في استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية، ولا كانت ذات صلة، في أي من الحروب الفعلية التي خُوضت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ففي خضم الحرب الباردة، لم تقتصر ساحة المعركة بين واشنطن وموسكو على ساحاتٍ تقليدية، بل اتخذت صراعًا غير مباشر عبر حروب بالوكالة في مختلف أنحاء العالم. من كوريا وفيتنام إلى أنغولا وأمريكا اللاتينية، دارت رحى الصراع من خلال جيوش تقليدية وقوات بحرية وجوية. على الرغم من هيمنة القوة النووية في تلك الحقبة، برزت أهمية القوات التقليدية بشكلٍ جليّ. ففي حين اعتقد البعض أنّ عواصم الدولتين العظيمتين هي مراكز القوة، كانت الصراعات الحاسمة تدور رحاها على أطراف بعيدة مثل إنشون ودلتا نهر الميكونغ ولواندا والسلفادور. لم يكن معيار النصر في تلك الحروب حجم الترسانات النووية الضخمة، بل تمثّل في فعالية دعم الحلفاء المحليين في مختلف أنحاء العالم النامي. باختصار، خلقت الترسانات الاستراتيجية للقوى العظمى، بضخامتها التي لا تتناسب مع الأهداف السياسية الواقعية، وهمًا زائفًا بالقوة المطلقة، سرعان ما كذّبته مجريات الأحداث على الأرض.
لقد طُمست هذه التشققات في النظام، إلى حد ما، بسبب الدور المهيمن للولايات المتحدة، وبسبب استعدادها، بل وحرصها في بعض الأحيان، على التدخل لملء الفراغ بشكل أحادي أو مع تحالفات مع القوى الأخرى. إلا أن نطاق الهيمنة الأمريكية بهذا الشكل يتقلص نتيجة لعدد من العوامل الموضوعية.
هناك سببان رئيسان وراء قصر مجال الهيمنة الأمريكية:
أولاً: خاضت أمريكا ثلاث حروب متتالية كان لها تداعيات داخلية كبيرة: فيتنام والعراق وأفغانستان. هذا النمط من التدخلات العسكرية سينتهي لأن الرأي العام الأمريكي سيصر في المستقبل على وضوح الأهداف، والتأكيد على مخططات لا لبس فيها حول إمكانية تحقق تلك الأهداف. كما لن يتم المجازفة بخوض الحروب، إلا لتحقيق نتائج ملموسة، وليس من أجل مفاهيم مجردة مثل بناء الدولة.
ثانياً: ستؤدي الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة وتحالف الأطلسي حتماً إلى ضغوط على الميزانيات العسكرية، مما يقيد نطاق التدخل ويفرض الحاجة إلى تحديد الأولويات.
في الوقت ذاته تظل الولايات المتحدة أقوى قوة فردية في العالم. على الرغم من تقييد قدراتها الفردية، إلا أنها لا تزال العنصر الأساسي في أي نظام أمني جماعي. لكنها لم تعد في وضع يسمح لها بالهيمنة المطلقة. لذا يجب عليها أن تتقن فن القيادة ليس كقائد وحيد بل كجزء من عالم معقد متشعب. وفي نهاية المطاف، سوف يكون لزاماً عليها أن تشارك في مسؤولية النظام العالمي مع مراكز القوة الناشئة، كي لا تقع ضحيةً لما أسماه بول كينيدي بـ “التمدد الإمبريالي المفرط”.
توقع بعض المحللين عالماً متعدد الأقطاب، حيث تقوم قوى إقليمية كبرى مثل روسيا والصين والهند والبرازيل وتركيا بحشد جيرانها الأصغر منها لتشكل مع بعضها البعض تكتلات قوى جيوسياسية فيما بينها لتخلق توازناً عالمياً فيما بينها. لكنني لا أعتقد أنه من الممكن تقسيم النظام الدولي إلى نظام من القوى الإقليمية المهيمنة. فالولايات المتحدة دولة في المحيط الهادئ؛ أي لا يمكن استبعادها عن شرق آسيا، وكذلك الصين أو الهند لا يمكن فصلهما عن الشرق الأوسط والمناطق الغنية بالموارد الأخرى. فقضايا مثل الطاقة أو البيئة أو الانتشار النووي، لا يمكن تحويلها لمسائل إقليمية بحتة، فهي قطعًا تتطلب مقاربات عالمية.
لقد صاغ نيال فيرغسون مصطلح “عالم بلا أقطاب”، حيث تتراجع الولايات المتحدة المنهكة تدريجيًا عن دورها في الهيمنة على العالم ولكن شريطة ألا يحل محلها أحد. وفقًا لهذه الرؤية، فإن الصين ستركز بشكل كبير على الحفاظ على الاستقرار بينما تقوم بتحديث مجتمعها بحيث لا تتحمل التزامات دولية واسعة النطاق. أما أوروبا فستعاني من تراجعها السكاني على المدى الطويل. وفي غياب سيادة عالمية حامية للقوانين، سيتمزق العالم في دوامة من الصراعات الدينية والصراعات الداخلية المحلية وإرهاب الميليشيات المارقة عن القانون الدولي مثل تنظيم القاعدة.
يقال أن الطبيعة تكره الفراغ، وكذلك يفعل النظام الدولي. فالفوضى، إذا حدثت، ستستقر عاجلاً أم آجلاً في نظام جديد. لذا من واجب رجال الدولة محاولة تحقيق ما يجب أن يتحقق في نهاية المطاف، وتجنيب الإنسانية معاناة لا تطيقها. وربما حان الوقت للنظر في نهج عملي في التعامل مع قضايا النظام العالمي. فقد ظهر الاتحاد الأوروبي في النهاية لأنه في غياب تكوين سياسي عالمي، نشأت كيانات وظيفية مثل الاتحاد الأوروبي، كيانات وظيفية تجمع بين البلدان ذات المصالح المماثلة في مشروع مشترك؛ فكانت مجموعة الفحم والصلب الأوروبية خطوة ضرورية.
هل من الممكن بناء نهج وظيفي على نطاق أوسع من الإقليمي ولكن أقل من العالمي، مع قيام الدول الأكثر تأثيرا بدور ريادي؟ الحقيقة نعم وأفغانستان مثال على ذلك. فلا تكاد توجد دولة في المتناول الاستراتيجي لأفغانستان أو في نطاقها، لها مصلحة في رؤية انتصار حركة طالبان أو وجود القاعدة كدولة داخل دولة أو احتمال تقسيم البلاد إلى عناصر بشتونية وغير بشتونية. حتى إيران، كدولة شيعية، لابد وأن ترغب في منع النظام الأصولي المناهض للشيعة من العودة إلى السلطة في كابول. بالنسبة لباكستان، فإن صعود الجهاديين الإسلاميين في دولة مجاورة من شأنه أن يزعزع استقرار النظام الباكستاني. ولدى الهند كل الدوافع لمنع اشتعال الحماسة الجهادية والانتصارات السياسية لهم. أما جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، مثل أوزبكستان وطاجيكستان، فستعاني من زعزعة الأمن بسبب الاضطرابات العرقية والنزعات الانفصالية التي ستندلع في أفغانستان إذا نجح المتعصبون البشتونيون في الوصول إلى السلطة. كذلك تأثير الإسلاموية المتطرفة على شينجيانغ يحدد المصالح الصينية المحتملة.
تملك كل هذه الدول مصلحة أكثر حيوية في دولة أفغانية مستقرة ومتماسكة مقارنة بالولايات المتحدة. في الوقت الراهن، يتم تبرير دور الولايات المتحدة للشعب الأمريكي على أساس أنه يخدم مصلحة وطنية حيوية، وهو مبرر مقبول من قبل أطراف المنطقة لأنهم يعلمون أننا لا ننوي التواجد الدائم في أفغانستان. بيد أن الدور الأمريكي الأحادي الجانب من غير الممكن أن يشكل حلاً طويل الأمد. فإن الحل الطويل الأمد لابد أن يشمل اتحاداً من البلدان لتحديد هوية ذلك البلد، ثم حمايته وضمانه. لذا يجب أن يكون دور أمريكا داعمًا وليس دورًا مركزيًا متحكمًا. القضية الأساسية هي ما إذا كان يمكن بناء هذا النهج الوظيفي بشكل متزامن مع الجهد الأمريكي الأحادي الجانب، أو يجب أن ينتظر نهايته، إما بالنجاح أو بالفشل. ستكون نهاية مؤسفة إذ ما كانت النتيجة مخيبة للآمال.
وفي مثل هذا النهج والنظام الدولي تشكل العلاقة بين أمريكا والصين عنصرًا أساسيًا. وقد يعتمد عليها مستقبل السلام والنظام العالمي. وقد عقد العديد من الكتاب تشبيهًا بين صعود الصين كقوة عظمى ومنافسة محتملة للولايات المتحدة اليوم وبين صعود ألمانيا في أوروبا قبل مائة عام، عندما كانت بريطانيا القوة الدولية المهيمنة ولكنها لم تستطع آنذاك احتواء ألمانيا.
أما حالة الصين فهي أكثر تعقيدًا. ليس الأمر محصورًا في كونها دولة قومية متكاملة على الطراز الأوروبي، بل أكثر من ذلك في كونها قوة قارية كاملة. يرافق صعودها تغيرات اجتماعية واقتصادية هائلة، وفي بعض الحالات، تفككات داخلية. إن قدرة الصين على الاستمرار في إدارة ظهورها كقوة عظمى جنباً إلى جنب مع تحولها الداخلي هي واحدة من الأسئلة المحورية في عصرنا.
كما أن المشاركة الشعبية المتزايدة ليست بالضرورة الطريق الحتمي للمصالحة الدولية، كما يُزعم غالبًا. فقبل قرن من الزمان، كانت ألمانيا تسمح تدريجيًا بمزيد من حرية التعبير والصحافة. لكن هذه الحرية الجديدة التي ظهرت في المجال العام أعطت متنفسًا لمجموعة متنوعة من الأصوات، بما في ذلك نزعة شوفينية تصر على سياسة خارجية أكثر جسارة. ومن المفيد لزعماء الغرب أن يضعوا هذا في اعتبارهم عندما يهاجمون الصين بشأن سياساتها الداخلية.
وهذا ليس المكان المناسب لمراجعة نطاق التفاعلات الأميركية والصينية. أود أن أختتم بنقطة عامة واحدة: كلا البلدين لا يمثلان أمتين بالمعنى الأوروبي بقدر ما يمثلان تعبيرات قارية عن هوية ثقافية. وكلاهما يفتقران لأية خبرات في العلاقات التعاونية مع الأنداد. ومع ذلك، لا توجد قضية أكثر أهمية أمام قادتهما من تطبيق حقيقة مفادها أن أيًا من البلدين لن يتمكن من السيطرة على الأخر، وإن الصراع بينهما من شأنه أن يستنزف مجتمعاتهما ويقوض احتمالات السلام العالمي. مثل هذه القناعة هي الشكل النهائي للواقعية السياسية في أعلى صورها.