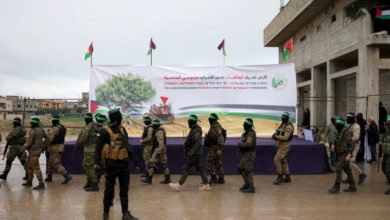الوجه الآخر لأمريكا
حازم كويي
دوروتيا شميدت
ترجمة:حازم كويي
هل تسود رأسمالية الدولة في الولايات المتحدة؟ يبدو السؤال شبه جنوني بالنظر إلى ليبرالية السوق التي تمثلها الدولة.
أرض الأحرار، موطن الشجعان. كانت هذه هي الصورة الذاتية للولايات المتحدة الأمريكية منذ القرن التاسع عشر، وهكذا تمت كتابتها في نص النشيد الوطني Star-Spangled Banner لعام 1814. منذ ذلك الحين، أصبح هذا الادعاء غالباً ما تُرجم إلى شعار “الأسواق الحرة، والمشاريع الحرة، والتجارة الحرة” ، كما ترجمه الرئيس جورج دبليو بوش في أكتوبر 2008، بعد أسابيع قليلة من إنهيار أكبر البنوك في ولايته وبدء عمليات الإنقاذ الحكومية لها. في نظريات العلوم الاجتماعية، يُنظر إلى الولايات المتحدة أيضاًعلى أنها حالة نموذجية لاقتصادات السوق الحرة، على سبيل المثال في النظرية المؤثرة لأصناف الرأسمالية التي كتبها بيتر أ.هول وبيتر سوسكه في “اقتصاديات السوق المنسقة”.
لكن في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن “عودة الدولة القوية”، وهو ما يرتبط بشكل أساسي بحقيقة أنه منذ الأزمة المالية لعام 2008، تم وضع حُزم إنقاذ للشركات الخاصة في العديد من البلدان، وبرامج التحفيز الاقتصادي، التي تم تمريرها ونظمت الأسواق المالية بشكل أكثر صرامة. كان “المجمع الصناعي العسكري” (MIC) موجوداً في الولايات المتحدة لفترة طويلة، وعند ألقاء نظرة فاحصة عليه، يتبادر إلى الذهن شيئان:
أولاً، يتميز MIC دائماً بالتفاعل الوثيق الذي شكلته الدولة ورأس المال.
ثانيًا، يمكن أيضاً ربط مصالح هذين الجانبين بطريقة مختلفة تماماً.
بدايات مجتمع التلاؤم.
لا يعود مصطلح “المجمع الصناعي العسكري” إلى الأصوات المناهضة للجيش، كما يُفترض غالباً، بل يعود إلى جنرال من الحرب العالمية الثانية هو الرئيس الأمريكي اللاحق دوايت دي أيزنهاور.
عام 1961، وفي نهاية ولايته الثانية، ألقى خطاباً ينتقد بيئة حياته المهنية التي أمضى فيها عقوداً، كان فيها على الدوام مخلصاً لمؤسساتها. حيث أختبر من أن سياسة الانفراج التي كان يتصورها تجاه الاتحاد السوفييتي قد تم تخريبها من قبل “صقور” الحرب المجانين في الجيش الأمريكي وفي البنتاغون، وهو الآن يشعر بأنه مضطر للتحذير من أن “المجمع الصناعي العسكري” “يمكن” التدخل بشكل غير مصرح به.
منذ ذلك الحين، يُنظر إلى MIK (المجمع الصناعي العسكري) على أنه مجتمع ملائم بين صناعة الأسلحة والجيش وأجزاء من الجهاز السياسي، مما يفرض في نهاية المطاف عسكرة مستمرة أو متزايدة للمجتمع دون سيطرة ديمقراطية. كانت بداياتها محلية خلال الحرب العالمية الأولى، عندما تم إنشاء لجان تخطيط التسلح التي تعاون فيها مصنعوا الأسلحة والجيش والحكومة. كما تم إنشاء مجلس موارد الحرب خلال الحرب العالمية الثانية، والذي كما كان من قبل، يتألف من قادة الصناعة ومكاتب المشتريات للأسلحة الفردية. خلال الفترة من 1945 إلى 1960، وخاصة في فترة الحرب الكورية، بلغ متوسط الإنفاق العسكري الأمريكي حوالي 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، وحوالي 20 في المائة من الإنفاق الحكومي.
كان هناك إنخفاض كبير في التسعينيات بعد نهاية الحرب الباردة، ولكن بعد ذلك أنتعش الإنفاق العسكري مرة أخرى، وكان آخر مرة عند 3.1 في المائة من الناتج القومي الإجمالي عام 2020. الولايات المتحدة هي واحدة من الدول الرائدة في العالم، وتمثل حالياً حوالي 40 في المائة من الإنفاق العالمي على الأسلحة. وبلغت ميزانية وزارة الدفاع لعام 2020 (761) مليار دولار، وكانت أعلى من إجمالي إنفاق الصين والهند وروسيا والمملكة العربية السعودية وفرنسا وألمانيا وثلاث دول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتم تمويل جزء كبير من الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة من أموال خفية أو إدارات أخرى، وعلى الأخص الأسلحة النووية من قبل وزارة الطاقة ووزارة الأمن الداخلي،التي أُنشئت حديثاً بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.
على الجانب الآخر توجد الشركات. ففي عام 2021، كانت خمس شركات لبيع الأسلحة في العالم أمريكية، أكبرها في العالم هي لوكهيد مارتن ورايثيون وبوينغ ونورثروب غرومان وجنرال دايناميكس. الفضاء هو محور الأنشطة التجارية لجميع الشركات الخمس، وغالباً ما يكونون هم المتعاقدون الوحيدون مع وزارة الدفاع لأنواع معينة من الطائرات أو المروحيات أو الصواريخ أو الطائرات بدون طيار.
المجالات الأخرى لصناعة الأسلحة، ولا سيما بناء السفن وتصنيع الذخيرة للأسلحة الكبيرة، كانت دائماً شديدة التركيز، ولكن حتى مطلع الألفية، كانت أجزاء كبيرة من المشتريات لا تزال تنفذ من قبل عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، فإن التخفيضات (المؤقتة) في ميزانيات التسلح بعد نهاية الحرب الباردة تسببت في وقوع العديد منهم في مشاكل، مما أدى إلى أن تُشترى من قبل الشركات الكبرى. بهذه الطريقة أستمر عدد المتعاقدين مع البنتاغون في الانخفاض.
الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات، تعتبر عقيدة جديدة في التسعينيات، وبدأ الجيش بوسيلة مجربة ومختبرة لمواجهة الانتقادات التي يتم الإعراب عنها كثيراً بشأن الميزانيات الدفاعية المفرطة. لكن في نهاية المطاف، كانت شركات الأسلحة الكبيرة هي التي أستولت مرة أخرى على مجالات الأعمال الجديدة والمربحة ونوعت عروضها. هكذا برزت شركة لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس “وول مارت أوف وور”. »Walmarts of War«.
العلاقات العامة لصناعة التسلح.
ليس من المؤكد أن الدول الرأسمالية لديها نفقات تسليح عالية – في اليابان، على سبيل المثال، أقل بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة، أي 1.1 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. لذلك يبقى أن نوضح كيف تمكنت MIK من ترسيخ نفسها بإصرار في المجتمع الأمريكي. تتمثل إحدى الطرق التي تقوم بها صناعة الدفاع في القيام بذلك عن طريق بدء وإطلاق الأخبار والخبرة حول التهديدات المتطورة باستمرار. خلال الحرب الباردة، على سبيل المثال، حدث هذا جنباً إلى جنب مع سلاح الجو. هنا،أثيرالتأكيد وطرح الأدعاء بوجود فجوة أمام قاذفات صواريخ الأتحاد السوفيتي وبعد إطلاقها أول صاروخ سبوتنيك هناك، تبين فيما بعد أن الفجوات غير موجودة.
في ثمانينيات القرن الماضي، تولت مراكز الفكر والرأي الكبيرة المعالجة الأيديولوجية لصانعي القرار السياسي. تم تمويل المعاهد مثل مشروع القرن الأمريكي الجديد إلى حد كبير من خلال تبرعات من صناعة الأسلحة وكانت مجهزة في المقام الأول بموظفين من رتب عسكرية. بعد انتهاء الحرب الباردة، أُعلن أن “الدول المارقة” إيران والعراق وليبيا وكوريا الشمالية وكوبا ونيكاراغوا تشكل تهديداً جديداً. ومن أجل التصدي ضدهم، سيتعين على الولايات المتحدة الحفاظ على أنظمة الأسلحة الكبيرة المطورة سابقاً وتوسيعها.
نتيجة أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تم إعلان “الحرب على الإرهاب” وتم تصنيف ثلاث دول على أنها “محور الشر”: إيران والعراق وكوريا الشمالية. أصبح المفهوم السابق لـ “الدول المارقة” مرتبطاً الآن بالقتال ضد شبكة القاعدة الإسلامية، وبالتالي إضفاء الشرعية على غزو أفغانستان. نجحت القطاعات المهيمنة في صناعة الأسلحة في المطالبة بتكثيف الدفاعات ضد الصواريخ بعيدة المدى على وجه الخصوص، بغض النظر عن تجربة أن الهجمات الإرهابية عادة ما تتخذ شكلاً مختلفاً تماماً، أي باستخدام العبوات المتفجرة أو الأسلحة الرشاشة.
ومع ذلك، أثبتت مبررات الحروب المكلفة للغاية في العراق وأفغانستان بشكل متزايد أمام الرأي العام بأنها هشة، بعدها تم تحديد العدو التالي منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي: الصين المُنافسة الاقتصادية والسياسية التي يفترض أنها من الناحية العسكرية، ترجمت أستراتيجيتها الجديدة في المقام الأول إلى حاجتها المتزايدة للتكنولوجيات والأسلحة في الاتصال والمراقبة والاستطلاع.
حتى الآن، يبلغ إنفاق الصين على الجيش حوالي ثلث إنفاق الولايات المتحدة (بالقيمة المطلقة) لكنه يتزايد باطراد. هنا أيضاً، لجأ البنتاغون إلى مفهوم “الفجوة” الذي تم إختباره واكتشف “فجوة في السفن” فيما يتعلق بالصين،التي تمتلك قدرة قتالية تبلغ 360 سفينة، بينما تمتلك الولايات المتحدة 297 سفينة فقط. السفن الصينية في الغالب صغيرة بالنسبة لخفر السواحل، في حالة الولايات المتحدة، غالباً ما يكون عدداً كبيراً من الغواصات المضادة للصواريخ برؤوس حربية نووية. ومع ذلك، فقد نجحت في جعل الصين “التهديد الأول” القادم للأمن الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ – وهو المبدأ الذي لا يزال سارياً حتى اليوم.
شروط منح العقود.
إن التأكيد على أن المنافسة بين الشركات يمكن أن تتطور بحرية داخلها، وهو شريان الحياة للسوق الليبرالية. يكمن الاختبار في ممارسة منح العقود الحكومية، مناقصة مكتوبة أومباشرة؟ في وقت مبكر من الستينيات، تم تطبيق النموذج الثاني على أكثر من 80 بالمائة من مشتريات وزارة الدفاع، وفي أوائل الثمانينيات على 96 بالمائة، ويقال إن شراء اللوازم المكتبية فقط قد تم طرحه للمناقصة. عندما تم تطوير آلات الحرب الجديدة، نصت العقود على تعويض الشركات التي تم تكليفها، بالتكاليف ثم إضافة هامش ربح إلى هذا المبلغ – لذلك كان من الواضح أن هناك حافزاً لزيادة التكاليف. في حين أن وزارة الدفاع قامت بمحاولات متكررة للحد من التكاليف مقدماً أو للاتفاق على الأهداف، إلا أن هذه الجهود لم تحقق نجاحاً يذكر. غالباً ما كانت الزيادات الهائلة في التكلفة مرتبطة في كثير من الأحيان بحقيقة أن إدارة وزارة الدفاع التي تمنح الأوامر صاغت باستمرار متطلبات جديدة في تطوير أنظمة الأسلحة المعقدة.
أستمرت ممارسة السداد للشركات عن التكاليف التي تم ترميزها بعد ذلك، وأصبحت لاحقاً أكثر تعقيداً مع زيادة عدد المقاولين والثانويين،الذين يشملهم هامش الربح أيضاً. أخيراً، وتحت ضغط مصانع السلاح، أصدر البرلمان الأمريكي لوائح يتم بموجبها الاستغناء عن توزيع تفاصيل التكاليف تماماً. وبدلاً من ذلك، كان كل ما هو مطلوب هو أعتبار السلع والخدمات المقدمة إلى وزارة الدفاع “تجارية”، لذلك يمكن مقارنتها بالمنتجات المدنية القابلة للتسويق، وهو أمر غير مقنع للغاية في حالة الطائرات المقاتلة أو الصواريخ أو الأجهزة الإلكترونية الخاصة، التي لا يُسمح للمشترين المدنيين بشرائها على الإطلاق. وخلص خبير المحاسبة تشارلز تيفر إلى أن “أساليب الغرب المتوحش” هي السائدة هنا.
خلقت ممارسة المشتريات العسكرية والصيانة هذه ثقافة واسعة النطاق لسوء الإدارة والهدر. في وقت مبكر من عام 1969، عقدت لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي جلسات إستماع مكثفة حول هذا الموضوع، وكانت النتائج مدمرة: من أصل 13 مشروعاً رئيسياً للقوات الجوية والبحرية بقيمة إجمالية قدرها 40 مليار دولار أمريكي، لم تكن الأنظمة الإلكترونية تعمل بشكل مُرضٍ،حتى ولو بنسبة 40%، وكان على مشروعين منهما التوقف والاستسلام كلياً بعد إستثمارات كبيرة. بالنسبة لصناعة الطيران على وجه الخصوص، تُظهر التقارير وجود عيوب متكررة في الجودة وتجاوزات في التكاليف للعقود التي تلت ذلك، وحتى المنفعة العسكرية (“قيمة المنفعة”) غالباً ما كانت موضع شك. ومع ذلك، فإن الأحكام بشأن عدم صلاحية الأسلحة لا تنطبق بأي حال من الأحوال على جميع مناطق الجيش. إن الأضرار المدمرة التي لحقت بالبشر والطبيعة والبلدات والقرى التي سببها الجيش الأمريكي في حروب العقود القليلة الماضية تشهدعلى ذلك.
مجموعة غلوب كسوق أسلحة.
يتعلق مستوى آخر من التفاعل بين الدولة وصناعة الأسلحة بصادرات الأسلحة، التي كانت دائماً مدعومة من الدولة. في الولايات المتحدة الأمريكية وخلال الحرب الباردة، كان هذا المبدأ يطبق على أن الأسلحة، كأداة للمنافسة المنهجية ضدالاتحاد السوفيتي، يجب أن يتم توفيرها لجميع البلدان التي تعاطفت مع الولايات المتحدة أو أرادت أن تكسبها إلى جانبها. في عام 1976، تم أخيراً تمرير قانون مراقبة تصدير الأسلحة (AECA)، والذي ينظم الكفاءات والمبادئ الخاصة بترخيص تصدير الأسلحة. وبناءاً على ذلك، يعود الأمر في المقام الأول إلى الرئيس للسماح لهم أو منعهم. لم يُمنح الكونغرس سوى سلطات محدودة لإبلاغه أو إصدار بيانات، يمكن للرئيس أن يستخدم حق النقض ضدها في أي وقت. بشكل أساسي، يجب على الدول المتلقية أستخدام الأسلحة لأمنها الداخلي أو للدفاع عن النفس “المشروع”. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تشجع قرارات التصدير سباقات التسلح وتطوير أسلحة الدمار الشامل والصراعات العسكرية. ومع ذلك، فإن كل هذه الصيغ غامضة للغاية لدرجة أنها جعلت من الممكن أيضاً إيصالها إلى مناطق الصراع الدولي وإلى الأطراف المتحاربة وفتحت بالفعل أسواق مبيعات لمصنعي الأسلحة الأمريكية في جميع أنحاء العالم.
بعد نهاية الحرب الباردة، تم تخفيض الميزانيات العسكرية في العديد من البلدان بشكل حاد في البداية، مما دفع شركات الأسلحة إلى تكثيف جهودها التصديرية. صعدت المملكة العربية السعودية لتصبح الدولة المستفيدة المفضلة، في حين أن الولايات المتحدة هي إلى حد بعيد الدولة الموردة الأكثر أهمية للمملكة العربية السعودية. الصفقة التي تربط البلدين تحت شعار “النفط مقابل الأمن”: السعودية تزود الولايات المتحدة بنفط يمكن الاعتماد عليه، بينما تزود الأخيرة البلاد بالسلاح، التي ينظر إليها على أنها ركيزة للاستقرار في المنطقة. لم يتم التشكيك في هذه العلاقات الراسخة حتى بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، على الرغم من أن غالبية القتلة جاءوا من المملكة العربية السعودية. لم تنزعج الحكومة الأمريكية أيضاً من حقيقة أن المملكة العربية السعودية كانت متورطة في الحرب الأهلية اليمنية منذ عام 2015، وحتى أغتيال الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي،حيث أدى فقط إلى تجميد مؤقت لإمدادات الأسلحة. في بلدان أخرى، تلعب القروض الرخيصة أو المنح غير القابلة للسداد من الولايات المتحدة دوراً، ويمكن ربط المساعدة العسكرية المدفوعة أيضاً بشراء الأسلحة من شركات الأسلحة الأمريكية.
تأثير سياسة”الباب الدوار”
ترتبط الأجزاء المختلفة للمجمع العسكري الصناعي ببعضها البعض على وجه التحديد من خلال ممارسة “الأبواب الدوارة”: كما لو كان أعضاء النخبة السياسية ينتقلون دون تردد إلى الإدارة العليا للشركات والعكس صحيح من خلال باب دوار. هذه الممارسة معروفة جيداً وقد أنتقدها عالم الاجتماع سي. رايت ميلز منذ خمسينيات القرن الماضي، عندما أظهر كيف أنتهى المطاف بالجنرالات السابقين في المراتب العليا للشركات متعددة الجنسيات بعد أنتهاء الخدمة العسكرية، وغالباً ما يتم التوسط من قبل الشركات الاستشارية: “بإستئجار جنرال “.
ومع ذلك، لم يؤثر ذلك إلا على دائرة صغيرة نسبياً، وفي ذلك الوقت كان من غير المناسب التحول إلى صناعة الأسلحة. لكن منذ ثمانينيات القرن الماضي، سقط هذا المحظور أيضاً وظهر شكل جديد من التداول، تَمثلَ في فرانك كارلوتشي، الذي كان وزيراً للدفاع ورائداً في عهد دونالد ترامب ثم تحول بسهولة إلى صناعة الأسلحة، ووضع النظام في أقصى القمة. خلال فترة عمله التي أستمرت أربع سنوات، كان لديه خمسة وزراء دفاع، أنضم ثلاثة منهم إلى الوزارة مباشرة من مصانع السلاح وهم: جيمس ماتيس من جنرال ديناميكس، باتريك شاناهان من شركة بوينج، ومارتن إسبر من شركة ريثيون.
بحلول عام 2010، أصبحت هذه الوظائف شائعة منذ فترة طويلة. عندما أنتقل شخص ما من مقاول دفاع إلى البنتاغون وشارك في التخطيط العسكري أو الشراء، كان من الطبيعي أن يمنح صاحب العمل السابق معاملة تفضيلية. وعلى العكس من ذلك، إذا ذهب شخص من البنتاغون إلى شركة أسلحة، فيمكنه جلب المعرفة التي كانت خاضعة رسمياً لواجب السرية، ولكن ثبت دائماً أنها مفيدة لصالح الشركة. وجدت دراسة أستقصائية أجريت عام 2006 باستخدام مصادر متاحة للجمهور، أن 52 متعاقداً رئيسياً مع البنتاغون وظفوا حوالي 2500 من الجنرالات السابقين أو الأدميرالات أو القادة السابقين لوكالات المشتريات العسكرية.
تضم هذه الشبكة أيضاً أعضاء في الكونغرس من الحزبين الأمريكيين الرئيسيين الذين مارسوا ضغوطاً من أجل زيادة الميزانيات العسكرية أو المشاريع العسكرية من قبل شركات معينة. يصف مستشار عسكري سابق مشاركتهم المستهدفة بـ “الهندسة السياسية”: “التحميل الأمامي”، أي العرض الإيجابي المفرط لمشروع التسلح،تتبعه “شبكة الأمان”، حيث يتم توزيع العقود بشكل خفي على أكبر عدد ممكن من الدوائر الانتخابية من أجل تأمين دعمهم.
حركات سياسية مضادة.
ومع ذلك، لا ينبغي أن يُنظر إلى MIK على أنه قوة طاغية لا يمكن السيطرة عليها، أستسلمت السياسة لها، ليصبح المجتمع فاقد الأمل. كانت هناك محاولات متكررة للرد أو حتى حل سلطته، على سبيل المثال، بعد الخطاب الوداعي ل أيزنهاور، دعا السناتور الديمقراطي جورج ماكغفرن إلى مفهوم مناهض جذري لـ MIK. لقد رأى إنفاق البنتاغون على أنه برنامج ضخم لخلق فرص العمل يجب إعادة توجيهه إلى أهداف أكثر أهمية، وأعتقدَ أن تحويل صناعة الدفاع أمر ممكن: “وظائف خضراء” لحماية البيئة. جاءت المقترحات في فجر أنتقادات واسعة النطاق للتدهور البيئي، والتي بلغت ذروتها في كتاب راشيل كارسون المذهل، الربيع الصامت (1962) وأنتجت العديد من المبادرات البيئية الملتزمة. صاغ ماكغفرن مشروع اللجنة الوطنية للتحول الاقتصادي، والذي قوبل باستجابة كبيرة عندما تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ في عام 1964، ولكن في النهاية لم يكن من الممكن حتى دفعه من خلال حزبه.
في الوقت نفسه، وفي المجال الأكاديمي، كان سيمور ميلمان من جامعة كولومبيا أول من تم في ظل توجيهه، فحص المثلث الحديدي للصناعات الدفاعية والجيش ووزارة الدفاع – بالنسبة له “رأسمالية البنتاغون” بالتفصيل. ومع ذلك، فإن المشاركة المتزايدة للحكومة في حرب فيتنام تعاملت مع الضربة القاضية لجميع مشاريع تحويل الأسلحة. قام جون كينيث غلبريث من جامعة هارفارد بمحاولة جديدة في السبعينيات. والذي نددَ أيضاً بالظواهر المعروفة الآن، المتمثلة في إرتفاع الأسعار وأوجه القصور الوظيفية الصارخة في صناعة الأسلحة ورأى الحل في التأميم. لقد نجح في كسب أقسام من النقابات إلى جانبه (“العمل من أجل السلام”) ، بينما اتُهم بخلاف ذلك في الأوساط السياسية بالخيالية أو إدخال الاشتراكية.
بعد أنهيار الاتحاد السوفيتي والأمل في “عودة السلام” للمشاريع المدنية، ظهرت العديد من الحركات الشعبية الجديدة، ولكن في النهاية – مع إجماع غير عادي بين الأحزاب – تم تمرير ميزانيات التسلح الضخمة بشكل متكرر في الكونغرس. يتم أنتقادهم حالياً فقط من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي، الذين ينتمون إلى التجمع التقدمي للكونغرس (CPC) ، أي الجناح اليساري للحزب.
في أبريل 2022، قدم الرئيس بايدن أقتراح ميزانية للعام المقبل،الذي سيمثل أعلى إنفاق عسكري في تاريخ الولايات المتحدة. والتبرير مع تزايد المهام الدولية والحرب في أوكرانيا. من ناحية أخرى، يجادل الحزب الشيوعي الصيني بأن الإنفاق الأمريكي، الذي يزيد بالفعل 10 مرات عن الإنفاق الروسي، لم يمنع روسيا من مهاجمة أوكرانيا. وبالتالي، فإن زيادة أخرى لن تجعل الوضع الدولي أكثر أماناً، ولكنها لن تؤدي إلا إلى زيادة تعزيز MIK وثقافتها المتعلقة بالهدر والحد من النطاق المالي لسياسة أجتماعية أفضل.
لا أحد يجرؤ على الأمل في التحول بعد الآن. أثبتت حركة السلام، التي كانت قوية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، أنها أضعف من أن تجعل مشاريع نزع السلاح والتحويل شائعة لدى الجمهور – وبالنسبة للحركات الاجتماعية، يبدو أن هناك قضايا أخرى مثل أزمة المناخ في المقدمة.ومع ذلك فإن المشاكل العسكرية والمناخية لها علاقة ببعضها البعض أكثر بكثير مما قد يعتقده المرء للوهلة الأولى، بالنظر إلى أن الجيش الأمريكي هو أحد أكبر بواعث ثاني أكسيد الكربون في العالم. إذا تم احتسابها كدولة، فستكون رقم 47 في القائمة ذات الصلة. ونأمل ونتمنى أن يكتسب إنتقاد الجهاز العسكري زخماً جديداً للحد منه.