عقيدة ايران السياسية و العسكرية
عندما عاد الخميني إلى إيران في عام 1979، لم تكن الثورة في بدايتها “إسلامية” بالمعنى الخالص، بل كانت تمثل تحالفاً عريضاً ضم ليبراليين، ويساريين، وقوميين، إلى جانب رجال الدين. لكن وثائق تاريخية نادرة، مثل تلك المحفوظة في الأرشيف البريطاني، تكشف أن الخميني رفض عروضاً مبكرة للتوافق. فقبل مغادرة الشاه، حاول التفاوض مع الخميني عبر وساطة فرنسية لتشكيل “حكومة وحدة وطنية” تحافظ على الملكية الدستورية، وهو العرض الذي رفضه الخميني قاطعاً باعتباره محاولة لتفريغ الثورة من مضمونها. هذا الرفض يُظهر أنه لم يكن مجرد لاعب ضمن تحالف عريض، بل كان يصوغ منذ البداية رؤية لسلطة بديلة كاملة، واستخدم التحالف كجسر تكتيكي مؤقت. ومع ذلك، سرعان ما برز تكتيك “العدو الخارجي” كأداة استراتيجية وظفها الخميني ببراعة، حيث استغل العداء للولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما خلال أزمة الرهائن، لإقصاء شركاء الثورة الآخرين. وهنا كان التوقيت مدروساً بعناية: فقد تزامن تصعيد أزمة الرهائن وتحويلها إلى أزمة مستعصمة (استمرت 444 يوماً) مع المراحل الحاسمة لصياغة الدستور والاستفتاء عليه، ثم الانتخابات الرئاسية الأولى. في كل محطة سياسية ديمقراطية محتملة، كان يتم تسخين الأزمة الخارجية لشيطنة الخصوم الليبراليين مثل الرئيس أبو الحسن بني صدر، وتصويرهم كعاجزين أو متواطئين مع “الشيطان الأكبر”. ومن خلال وصم الليبراليين واليساريين بصفات مثل “عملاء الغرب” أو “الطابور الخامس”، تمكن من تصفية المعارضة تحت شعار “حماية الثورة من الشيطان الأكبر”، مما أدى في نهاية المطاف إلى تحول النظام من “ثورة شعبية” شاملة إلى “سلطة الفقيه المطلقة” عبر استغلال حالة التعبئة المستمرة ضد الخارج.
ولم يتوقف الأمر عند تثبيت الحكم في الداخل، بل امتد ليشمل تساؤلات حول طبيعة التوجه الإيراني: هل كان “تصدير أزمات” أم “تصدير ثورة”؟ إذ يرى الكثير من المحللين أن الخميني كان يدرك تماماً أن الوعود الاقتصادية للثورة قد تصطدم بالواقع المرير، لذا كان بحاجة ماسة إلى “قضية عابرة للحدود” لإشغال الداخل. وتعد الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988) المثال الأبرز على ذلك؛ فقد كشفت وثائق داخلية للحرس الثوري أن القيادة الإيرانية، في ذروة الحرب (مثل عملية “كربلاء-5” في 1987 التي كادت تفتح طريقاً إلى البصرة)، رفضت عروضاً دولية لوقف إطلاق النار كانت ستضمن لإيران مكاسب إقليمية كبيرة. السبب الأيديولوجي المعلن كان “إسقاط صدام”، ولكن السبب الاستراتيجي الخفي كان الحفاظ على حالة “التعبئة الثورية الكلية” التي سمحت بإكمال عملية “تصفية” أو إسكات كل الأصوات الداخلية المتبقية، وترسيخ هيمنة الحرس الثوري على الاقتصاد والأمن. فرغم كلفتها البشرية والمادية الباهظة، استخدمها الخميني لفرض حالة الطوارئ الدائمة، وتخوين أي صوت معارض، وبناء “الحرس الثوري” كقوة موازية للجيش النظامي لضمان الولاء المطلق. وفي هذا السياق، أنشأ الخميني ومقربوه شبكة مالية سرية باسم “بندر التجاري” (مستوحى من ميناء بندر عباس) في أوائل الثمانينيات. كانت هذه الشبكة، التي تديرها مؤسسات وقفية (بنياد) مرتبطة مباشرة بالولي الفقيه، تعمل على تحويل الأموال النفطية والمساعدات إلى جماعات في لبنان وأفغانستان، ليس فقط لنشر الأيديولوجيا، بل لخلق نقاط توتر إقليمية تشغل أنظمة الخليج والغرب عن التدخل في الشأن الإيراني الداخلي أثناء الحرب. أي أن “تصدير الثورة” كان، في جزء كبير منه، أداة دفاعية استباقية لحماية المشروع الداخلي الهش. وبالتوازي مع ذلك، سعى النظام لتحقيق شرعية إقليمية عبر تبني العداء لإسرائيل، محاولاً سحب البساط من الدول السنية الكبرى وتقديم إيران كقائد “حقيقي” للعالم الإسلامي، وهو ما منحه نفوذاً يتجاوز الحدود الجغرافية واللغوية.
وعند التساؤل عما إذا كان الخميني “أحمقاً” في حساباته السياسية، نجد أن التحليل المعمق للدوافع يشير إلى خلاف ذلك؛ فبالمفهوم السياسي التقليدي، قد يبدو الدخول في عداء مع القوى العظمى نوعاً من “الانتحار”، ولكن من وجهة نظر الخميني، كانت العقيدة تتقدم على الحسابات المادية. لقد آمن بـ “النصر الإلهي” و”اقتصاد المقاومة”، وهذا الزهد في النتائج المادية جعل خصومه يجدون صعوبة بالغة في التنبؤ بتصرفاته. وهو، بتحليل أعمق، كان يستلهم نموذجاً استراتيجياً مماثلاً لـ “حرب الاستقلال الجزائرية”، حيث رأى أن الهوية الإسلامية الثورية الجديدة لا يمكن صهرها إلا عبر صراع وجودي مع قوة عظمى (كما صنع الجزائريون هويتهم عبر الحرب مع فرنسا). لذلك، لم يكن العداء للولايات المتحدة مجرد تكتيك، بل كان ركيزة أساسية في هندسة الهوية الوطنية-الدينية الجديدة التي أراد بناءها. ومن منظور البقاء الاستراتيجي، نجح الخميني في زرع نظام استمر لأكثر من 45 عاماً رغم كل الأزمات، وذلك لأنه فهم أنه لن يستطيع تقديم الرفاه الاقتصادي (عقد اجتماعي إيجابي). لذا، استبدله بـ “عقد اجتماعي سلبي” يقوم على مبدأ: “أنا أضمن بقاءكم وهويتكم وكرامتكم في مواجهة عالم معادٍ، وأنتم تتحملون الفقر والعقوبات”. هذه الصيغة حولت المعاناة الاقتصادية من فشل للنظام إلى دليل على صمود الأمة وتميزها الأخلاقي تحت قيادته. مما يشير إلى أن قراراته -وإن كانت مدمرة لرفاهية الشعب- كانت “ذكية” جداً في تأمين بقاء النخبة الحاكمة في السلطة.
بيد أن هذا المسار الذي بدأه الخميني كأداة لتثبيت الحكم، تحول بمرور الزمن إلى مأزق تاريخي وقيد يكبّل خلفاءه، حيث أصبح العداء لأمريكا وإسرائيل جزءاً من “الحمض النووي” للنظام. إن أي محاولة للتصالح الشامل مع الغرب اليوم تعني بالضرورة سقوط الشرعية الأيديولوجية التي بني عليها النظام منذ عام 1979، وهو ما يفسر حالة العجز التي تعيشها القيادة الإيرانية الحالية في عام 2026، حيث تجد نفسها عالقة في منطقة رمادية؛ فلا هي قادرة على خوض حرب شاملة، ولا هي قادرة على إبرام سلام كامل. المأزق الوجودي الحقيقي في 2026 ليس فقط في التضخم أو الاحتجاجات، بل في أن الآلية التي أوجدت النظام ومنحته القوة (التعبئة المستمرة ضد عدو خارجي) هي نفسها التي تستنزف مقومات بقائه الاقتصادية والديموغرافية والأمنية من الداخل، محولة إياه إلى قلعة محاصرة من الخارج، ومجوَّفة من الداخل. وبناءً على ذلك، لم يكن الخميني “أحمقاً” بالمعنى الذهني، بل كان أيديولوجياً راديكالياً استخدم الخارج ببراعة لصهر المجتمع في بوتقة واحدة تحت قيادته، إلا أن المأساة تكمن في أن التكتيك الذي أنقذ النظام في الثمانينيات هو نفسه الذي يضع الدولة الإيرانية اليوم في مأزق وجودي.
وتتجلى ملامح هذا المأزق في كون إيران اليوم نتاج “عقل غربي في جسد أيديولوجي”؛ فالخبرة الفنية التي تسمح لها بتصنيع المسيرات وتخصيب اليورانيوم هي في الأصل “بذرة” زرعها الشاه بتعليم عالمي، لكن نظام الخميني قام بتسييجها وتوجيهها نحو المواجهة بدلاً من الرفاهية الاقتصادية. ويعود هذا الفشل الاقتصادي إلى عدة أسباب رئيسية، أولها “عسكرة الاقتصاد” وهيمنة المؤسسات الموازية مثل الحرس الثوري والمؤسسات الدينية (بنياد) التي تسيطر على مفاصل الدولة دون خضوع للرقابة المالية أو دفع الضرائب. تقديرات صادرة عن مركز أبحاث اقتصادي أوروبي متخصص عام 2025 تشير إلى أن مجموع أصول هذه المؤسسات يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران، لكن أقل من 15% من أرباحها يدخل الميزانية العامة. إنها تعمل كـ “ثقب أسود مالي” تبتلع الموارد (عقارات، مناجم، عوائد تصدير غير مشروع) وتعيد تدويرها داخل دوائر السلطة والنفوذ الإقليمي، معزولة عن أي رقابة. ووفقاً لتقارير عامي 2025-2026، تستهلك الميزانية العسكرية والأمنية نحو 24% من الموازنة العامة، مما حول الاقتصاد إلى أداة لتمويل النفوذ الإقليمي بدلاً من كونه درعاً للمجتمع.
ويتعمق هذا الفشل بفعل الفساد البنيوي وما يعرف بـ “اقتصاد الريع”، حيث تحول شعار “اقتصاد المقاومة” في الواقع إلى “اقتصاد الالتفاف على العقوبات”، مما خلق طبقة من “تجار الحروب” والوسطاء المرتبطين بالنظام الذين يستفيدون من الحصار لغسل الأموال. ويقدر الخبراء أن تكلفة هذه المعاملات ترفع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 50%، مما يجعل أي محاولة للاكتفاء الذاتي غير مجدية اقتصادياً. كما فشل النظام في فك الارتباط بالنفط، وظل الاقتصاد رهينة لـ “أساطيل الظل”، وعندما شددت واشنطن الخناق عليها في أواخر عام 2025، انهار الدخل القومي فجأة، ولجأت الحكومة لطباعة العملة، مما رفع التضخم إلى مستويات كارثية تجاوزت 50% في أوائل عام 2026، مدمرةً بذلك القدرة الشرائية للطبقة الوسطى التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد مستقر.
وعلاوة على ذلك، أدت البيئة السياسية والأمنية القمعية إلى “نزيف العقول” وهجرة الكفاءات التي كان من المفترض أن تقود ثورة صناعية محلية، مما جعل إيران قادرة على هندسة الصواريخ عبر التقليد، لكنها عاجزة عن تصنيع أبسط التقنيات المدنية أو حل أزمات الكهرباء والزراعة. وقد ترافق هذا التدهور مع سقوط “العقد الاجتماعي” وإهمال الجبهة الداخلية، حيث بات المواطن يرى ثرواته تُنفق في صراعات إقليمية في سوريا واليمن ولبنان بينما يعاني هو من الجوع والجفاف. وتقارير استخباراتية غربية ترجح أن القيادة الإيرانية اتخذت قراراً استراتيجياً بعد احتجاجات “مهسا أميني” (2022) بتغيير نهجها الأمني. لم يعد الهدف مجرد قمع الاحتجاجات، بل تفكيك البنى الاجتماعية المتماسكة (مثل العشائر في سيستان بلوشستان، أو النقابات المهنية) التي يمكن أن تشكل نواة لمقاومة منظمة. هذا يفسر الارتفاع الهائل في حكم الإعدام، لا كرد جنائي فقط، بل كأداة هندسة ديموغرافية واجتماعية لإضعاف أي تجمع بشري قد يشكل تهديداً وجودياً في المستقبل. ونتيجة لذلك، تحولت الأزمات الاقتصادية إلى احتجاجات سياسية حادة، كما حدث في ديسمبر 2025، مما أجبر النظام على استنزاف موارده في الأمن الداخلي بدلاً من الإنتاج الحربي، لتفشل إيران في النهاية لأنها حاولت بناء “رأس حربي” عسكري دون “جسد سليم” واقتصاد مؤسساتي شفاف.
وفي ظل هذا الانهيار الداخلي، تبرز علاقة وثيقة يحللها الخبراء الأمنيون بين وتيرة القمع المرتفعة، وخاصة الإعدامات، وبين سهولة الاختراق الاستخباري وتجنيد العملاء. ففي عام 2025 وحده، سجلت إيران رقماً قياسياً بتنفيذ أكثر من 2200 حالة إعدام، مما خلق بيئة خصبة لـ “الانتقام الاستخباري” وكسر حاجز الولاء الوطني. فعندما تتوسع دائرة الإعدامات لتشمل مختلف الفئات والناشطين، فإنها تخلق جرحاً غائراً يدفع المتضررين للتعاون مع أجهزة استخباراتية أجنبية ليس من أجل المال دائماً، بل بدافع الانتقام ضد النظام الذي ظلمهم، حيث يصبح تسريب المعلومات في نظرهم “عملاً نبيلاً” لتقويض السلطة. وكشفت تحقيقات صحفية دولية عام 2024 حول اختراق كبير لمنشأة نطنز النووية عن نمط جديد: “المخبر المنتقم”. حيث تبين أن أحد مصادر التسريب كان ضابطاً سابقاً في الحرس الثوري تم فصله وتجريده من امتيازاته بعد اتهامات فساد كيدية من منافس داخل المؤسسة. هذا النمط يظهر أن القمع الداخلي الواسع في المؤسسات الأمنية نفسها يخلق طبقة من الخبراء المحترفين الذين يشعرون بالإهانة والتهديد، فيتحولون إلى مصادر خطيرة للتسريب بدافع الانتقام الشخصي أكثر من الدافع السياسي أو المالي.
ولم يقتصر “تأثير الارتداد” هذا على المعارضين فحسب، بل امتد ليشمل المؤسسات الأمنية نفسها، حيث دفع الخوف من الإعدامات الكيدية بتهم التجسس بعض الضباط والمهندسين للبحث عن “قوارب نجاة” عبر التواصل مع جهات خارجية لتأمين حمايتهم مستقبلاً. كما تآكلت الحاضنة الشعبية للمعلومات، خاصة في المجتمعات القبلية والعشائرية (الكردية والعربية والأذرية)، حيث دمر النظام الولاء “الرأسي” التقليدي للزعيم المحلي دون أن يبني ولاءً “أفقياً” مقبولاً لولاية الفقيه. هذا خلق فراغاً أمنياً هائلاً، حيث لم يعد الزعماء المحليون قادرين على ضبط مجتمعاتهم، ولم تكتسب الدولة شرعيتها بينهم. فالمواطن الذي كان يمثل المخبر الأول للأمن الداخلي، فقد ثقته في الشارع مع تحول الإعدامات إلى ظاهرة يومية، وبات يمتنع عن إبلاغ السلطات عن أي نشاط مشبوه نكايةً في النظام. وهكذا، فقد الردع قيمته بعدما أصبح الموت عقوبة لكل شيء، وأثبتت وقائع عامي 2025 و2026 أن القمع لم يمنع الاختراقات، بل زاد من وتيرتها وجعل إيران “مكشوفة أمنياً” من الداخل بشكل غير مسبوق، محولةً فئات واسعة من الشعب من مواطنين محايدين إلى خصوم كامنين يهددون بقاء الدولة من جذورها.
المرصدالاقليمي للدراسات الجبوبوليتيكية
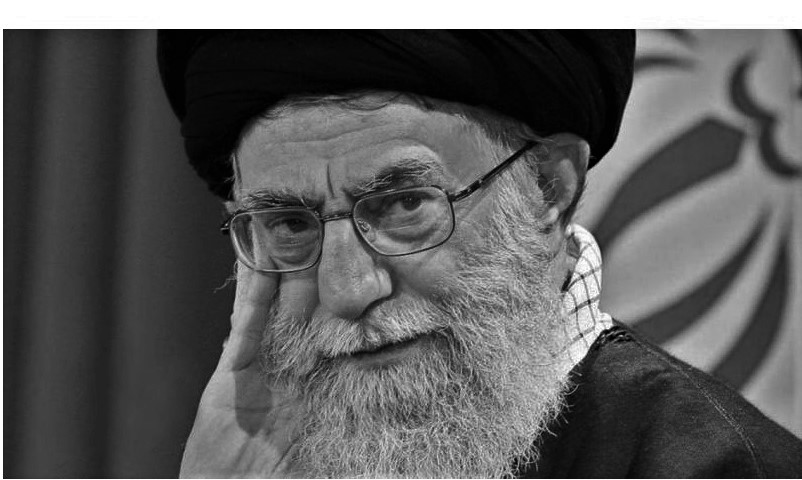













إرسال التعليق