
نرى الحقيقة… ثم نهرب منها؟
—
*
م. رشيد/ فوزي
*
لم أفهم يوما لماذا، كلّما تراءت لنا الحقيقة عارية أمام أعيننا، نتعامى عنها ونتظاهر بأننا لم نرَ شيئا. نُشيح بوجوهنا، نؤجّل الاعتراف بها، ثم لا نلبث – بعد فوات الأوان – أن نطالب بها وكأنها وُلدت لتوّها.
حين تستمع إلى الجزائري وهو ينتقد أوضاع حيّه أو بلدته، يخال لك للوهلة الأولى أنك أمام إنسان راقٍ، واعٍ، يرفض الفساد والرّداءة والانحطاط. تتوقّع منه موقفا شجاعا، سلوكا منسجما مع خطابه. لكن ما إن تطيل الجلوس معه، حتى تصدمك سلبية مقيتة، تثير الحزن و الاشمئزاز.
ستون عاما ونحن نسمع الكلام نفسه عن البلدية الفاشلة.. عن رئيسها الفاسد.. عن الرشوة المستشرية
و«البنعمّيس»… و عند أول امتحان حقيقي؛ مناسبة انتخابات، وفرصة تغيير، كأن تكون لحظة حسم.. فجأة يظهر إنسان آخر، يُدير ظهره لكل ما كان يردّده، ويتنكّر لكل المبادئ التي ظلّ يتشدّق بها، بل ويدافع وبكل مكر وخبث ودهاء.. عن الواقع ذاته الذي كان يلعنه بالأمس؟
بالأمس، وكما اعتدتُ في كل مناسبة تسمح بذلك، كتبتُ مقالا ألمّح فيه إلى ضرورة التفكير الجاد في معضلة ”تقزيم صلاحيات المنتخب المحلّي“، وتساءلت عن الصّمت الغريب للأحزاب التي ترشّح وجوها بلا شخصية وكفاءة ولا هوية، لتساهم، بقصد أو بغير قصد، في هذا العبث.
كنتُ أتوقّع تفاعلا، لا تصفيقا ولا تملّقا، بل مجرّد مشاركة، سواء بالقبول أو بالإعتراض، أو بأيّ شيء يدلّ على أنّ هناك مقاومة. لكن الخيبة كانت مخزية؛ صمتٌ ثقيل وبرودة قاتلة، كأنّ الكلام لا يعني أحدا، وكأنّ كل شيء صار أمرا عاديا لا يستحق حتى التعليق.
– هل ألوم الجرائد التي ترفض هذا النوع من الطرح لأنه “مزعج”؟
– أم ألوم أولئك المتلوّنين الذين يغيّرون مواقفهم كما يغيّرون ثيابهم؟
– أم ألوم نفسي، لأنني أقحمتُها في ما لا يعنيها؟
إنني لم أتدخّل طلبا لمصلحة، ولا بحثا عن دور، ولا رغبة في بطولة وهمية. تدخّلتُ بدافع الغيرة لا أكثر. غيرة على مكان أعرفه وأعيش فيه، وعلى فكرة ”وطن“ كان بالإمكان أن يكون أبهى وأفضل، لو انسجم القول مع الفعل.
لكن يبدو أن أكبر أزماتنا ليست في القوانين، ولا في الصلاحيات، ولا حتى في المسؤولين وحدهم… بل في هذا التناقض المزمن بين ما نقوله وما نفعله؛ بين غضبنا في المقاهي وصمتنا في صناديق القرار، بين شجاعتنا في الكلام وجبننا في المواقف.
نرى الحقيقة… ثم نهرب منها؟
—
*
م. رشيد/ فوزي
*
لم أفهم يوما لماذا، كلّما تراءت لنا الحقيقة عارية أمام أعيننا، نتعامى عنها ونتظاهر بأننا لم نرَ شيئا. نُشيح بوجوهنا، نؤجّل الاعتراف بها، ثم لا نلبث – بعد فوات الأوان – أن نطالب بها وكأنها وُلدت لتوّها.
حين تستمع إلى الجزائري وهو ينتقد أوضاع حيّه أو بلدته، يخال لك للوهلة الأولى أنك أمام إنسان راقٍ، واعٍ، يرفض الفساد والرّداءة والانحطاط. تتوقّع منه موقفا شجاعا، سلوكا منسجما مع خطابه. لكن ما إن تطيل الجلوس معه، حتى تصدمك سلبية مقيتة، تثير الحزن و الاشمئزاز.
ستون عاما ونحن نسمع الكلام نفسه عن البلدية الفاشلة.. عن رئيسها الفاسد.. عن الرشوة المستشرية
و«البنعمّيس»… و عند أول امتحان حقيقي؛ مناسبة انتخابات، وفرصة تغيير، كأن تكون لحظة حسم.. فجأة يظهر إنسان آخر، يُدير ظهره لكل ما كان يردّده، ويتنكّر لكل المبادئ التي ظلّ يتشدّق بها، بل ويدافع وبكل مكر وخبث ودهاء.. عن الواقع ذاته الذي كان يلعنه بالأمس؟
بالأمس، وكما اعتدتُ في كل مناسبة تسمح بذلك، كتبتُ مقالا ألمّح فيه إلى ضرورة التفكير الجاد في معضلة ”تقزيم صلاحيات المنتخب المحلّي“، وتساءلت عن الصّمت الغريب للأحزاب التي ترشّح وجوها بلا شخصية وكفاءة ولا هوية، لتساهم، بقصد أو بغير قصد، في هذا العبث.
كنتُ أتوقّع تفاعلا، لا تصفيقا ولا تملّقا، بل مجرّد مشاركة، سواء بالقبول أو بالإعتراض، أو بأيّ شيء يدلّ على أنّ هناك مقاومة. لكن الخيبة كانت مخزية؛ صمتٌ ثقيل وبرودة قاتلة، كأنّ الكلام لا يعني أحدا، وكأنّ كل شيء صار أمرا عاديا لا يستحق حتى التعليق.
- هل ألوم الجرائد التي ترفض هذا النوع من الطرح لأنه “مزعج”؟
- أم ألوم أولئك المتلوّنين الذين يغيّرون مواقفهم كما يغيّرون ثيابهم؟
- أم ألوم نفسي، لأنني أقحمتُها في ما لا يعنيها؟
إنني لم أتدخّل طلبا لمصلحة، ولا بحثا عن دور، ولا رغبة في بطولة وهمية. تدخّلتُ بدافع الغيرة لا أكثر. غيرة على مكان أعرفه وأعيش فيه، وعلى فكرة ”وطن“ كان بالإمكان أن يكون أبهى وأفضل، لو انسجم القول مع الفعل.
لكن يبدو أن أكبر أزماتنا ليست في القوانين، ولا في الصلاحيات، ولا حتى في المسؤولين وحدهم… بل في هذا التناقض المزمن بين ما نقوله وما نفعله؛ بين غضبنا في المقاهي وصمتنا في صناديق القرار، بين شجاعتنا في الكلام وجبننا في المواقف.










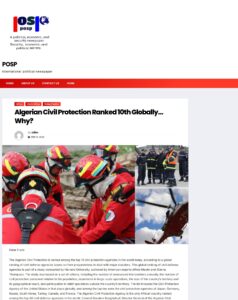








إرسال التعليق